الرثاء في الشعر العراقي
المعاصر: قصيدة "شاهدة قبر من رخام الكلمات" ليحيى السماوي أنموذجا
حسين سرمك حسن
ناقد عراقي مقيم في دمشق
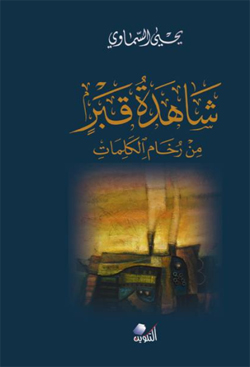
(الأحياء ينامون فوق الأرض.. الموتى ينامون تحتها.. الفرق بينهم: مكان
السرير .. ونوع الوسائد.. والأغطية)
(يحيى
السماوي)
(شاهدة
قبر من رخام الكلمات)
(إن ثمة شيئين لا يمكن أن يحدق فيهما المرء: الشمس والموت)
(لاروشيفوكو)
(إذا أردت ألّا تخشى الموت فإن عليك ألّا تكف لحظة عن التفكير به)
(سنيكا)
خاطيء ظن من يعتقد من النقاد أن الخنساء قد أقفلت باب فن
الرثاء بقصائدها العصماء التي رثت فيها أخاها صخر – وفي بطانة هذا الرثاء
تلوب شحنات التثبيت المحارمي – وأن الهذلي قد قدّم الأنموذج الذي لا يُبارى
في قصيدته التي يرثي بها أولاده / فلذات كبده. في العراق، سيكون فن الرثاء
هوآخر فنون الشعر التي ستنطفىء جذوتها، إذا افترضنا جدلا أن هناك ما يمكن
أن ينطفيء من الشعر الذي – بخلاف أطروحات الحداثة - لن يموت إلا بموت
الإنسان الأخير على وجه المعمورة. في هذه البلاد ؛ العراق، خلق الله
الإنسان وهويبكي، وهذا الوصف قلته في مقالة نشرت في عام 2002. على هذه
الأرض، وبخلاف كل البشر في أرجاء المعمورة خُلق الإنسان الأول من طين ودم،
وليس من طين وماء.. أُخذ الدم من عروق إله حزين منكسر ومقيّد. وفي بلاد
سومر، كانت في كل حي مجموعة من النسوة يسمين بـ " الندّابات " يدرن من بيت
إلى بيت في أوقات العزاء يهيجن الأحزان ويستثرن الدموع ويلهبن اللطم على
الصدور. ولم تلقب هذه البلاد بـ " أرض السواد " لكثافة غابات نخيلها، بل
لرهبة ذاك البدوي المصور وهويقترب منها مما سمعه واختزنه عن فاجعاتها
وظلمات عذاباتها. وإلا فقل لي يا " يحيى السماوي " لماذا لم يُطلق هذا
الوصف على عشرات ومئات الأمصار والبلدان التي فتحها العرب وكانت فيها غابات
كثيفة من الشجر من كلّ نوع وجنس؟؟ يحيى السماوي.. يقدم الجواب الشافي في
واحدة من عيون قصائد الرثاء في الشعر العربي - قديمه وحديثه -: " شاهدة قبر
من رخام الكلمات ". قصيدة يرثي فيها أمه التي، وبفعل إنثكاله المرير بها،
أهدى ديوانه الذي يحمل العنوان نفسه * إلى روحها: " إلى روح الطيبة أمي وقد
غفت إغفاءتها الأخيرة قبل أن أقول لها: تصبحين على جنّة "، وبهذا الإهداء
ختم السماوي على باب الديوان بشمع الأسى الأسود، وأغلق أبواب وشبابيك النص
ليجلس في ظلمة الإنكسار.. في وحشة منفاه باستراليا.. وفي بيت الديوان
المظلم جاءت كل القصائد عبارة عن مرثية طويلة مدمّرة، لم تسلم منها حتى
قصائد الغزل وستكون لنا وقفة في هذا الجانب. وقصيدة الرثاء هذه: " شاهدة
قبر من رخام الكلمات " * هي من قصائد النثر.. ومن الافتراضات الأساسية التي
أنا مقتنع بها بشكل عام كقاعدة هي أن قصيدة النثر لا تصلح للرثاء بسبب
فقدانها للإيقاعية المطلوبة لنواح النفس البشرية الحزين، وبسبب لعبها
الذهني على الصور حيث نحتاج مسافة عقلية تسبق الإنفعال المحتبس فتجهضه. لكن
لاشيء مستحيل، ولنقل عسيرا على الشاعر الكبير المقتدر. كسر يحيى هذه
القاعدة، مثلما كسرها " جواد الحطاب " في قصيدته النثرية " استغاثة الأعزل
" الهائلة التي رثى بها الشهيدة " أطوار بهجت " والتي نشرت دراستنا عنها في
صحيفة " الزمان ". لكن قصيدة
السماوي ليست نشيج روح ممزقة يركبها الشعور بالإثم المبرر
لأن الأم العظيمة رحلت كسيرة في السماوة، فقد طوى الجزيرة.. أي جزيرة؟؟..
طوى خبر موتها القارات ليصل ابنها في منفاه في استراليا. وفي العراق، وكلما
أراد الإبن التحرر من الرابطة الأوديبية المكينة المغلفة بالحنان البريء
الخانق للأم.. تصيح الأم: إذا سافرت.. وتغربت.. من الذي سيدفنني؟؟:
( آخر أمانيها:
أن أكون... من يُغمض أجفان قبرها... آخر أمنياتي... أن تغمض بيديها
أجفاني... كلانا فشل... في تحقيق.. أمنية... متواضعة – ص 12و13 ). هذه
القاعدة في العراق شذّ عنها السماوي مكرها ؛ هوالذي أفلت من منجل الطغاة
المجتث الأعمى بأعجوبة. لكن لا تبرير ولا عقلنة يمكن أن تطفئ الإحساس
بالذنب تجاه مخلوقة هي سبب الوجود: ( لي الآن سبب آخر.. يمنعني من خيانة
وطني: لحاف سميك من ترابه.. تدثرت به أمي.. ووسادة من حجارته.. في سرير
قبرها – ص 7 ).
وحين تبحث في سيكولوجية الخونة تجد دائما ثغرة جارحة في
العلاقة بالأبوين، الأم خصوصا، وليس معنى ذلك أن كل من تربطه علاقة سيئة
بأمه يخون بلاده، لكن كل من يخون بلاده، في الغالب، يركبه، منذ الطفولة
المبكرة، خلل عميق مختزن في أعماق اللاشعور. ألا يُقال أن توظيف العملاء
يقوم دائما على محاصرة الفرد بإغواء المال والمرأة؟!. الولاء اللاحق
للأوطان / الرحم يتأسس على ويأخذ معانيه من الولاء السابق للأمهات.
والسماوي حين يقدّم سببا مضافا لولائه المستميت لتراب وطنه المقدّس /
التراب الذي احتضن جسد الأم الطهور في عودة مباركة إلى الرحم الأكبر، فإنه
إنما يقرّر حقيقة أن الأرض / الرحم الأكبر / الأم الكونية / البلاد التي
احتوت جسد أمه، هي إنما تضم الأرض التي بذرت فيها بذرة وجوده، والرحم
الأصغر ماديا لكن الأكبر بمعانيه الرمزية الكونية.. فهوالأرض.. والخصب..
والطبيعة.. والكون.. والحياة.. والوطن الذي صار يحيى الآن – وكما يقول -
مدينا له حتى الموت، ولعل هذا من عوامل موقفه الصلب الرافض للإحتلال. إذ
كيف يتحمل أحدنا أن يدوس حذاءٌ غاصبٌ الترابَ الذي يضم جثمان أمه. ولاحظ
أننا نصف الإحتلال بالإغتصاب مثلما نصف حال المرأة التي تُفترع كرها رغم
إرادتها. وسنلاحظ أن القصيدة في مبناها، ومنذ مقطعها الأول هذا، مصوغة بلغة
غنائية شفيفة، بسيطة لكن ليست سهلة بحيث تقع في دائرة الإبتذال. هذه اللغة
انحدرت إلى مسرى قصيدة النثر من عطايا ينبوع مهارات الشاعر في القصيدة
العمودية ( لذا أقول على كل شاعر شاب أن يتمرس في العمود قبل أن ينغمس في
تيار قصيدة النثر ). الشاعر يدرك أن الرثاء لا يمكن أن يتحمل ألعاب قصيدة
النثر الملغزة والشائكة. حين أقرأ مقطعا يتحدث عن أمي الراحلة وأفكر دقائق
كيف أنها " الوضوح الأزرق المنبعج في بحر آثام اللازورد "، فإن فسحة
التفكير الذهني هذه ستجهض العاطفة المحتبسة التي تكاد تطفر من العينين
الغائمتين. ولذلك صاغ السماوي وبذكاء مرثية سيبكي لها كلّ مثكول قادر على
القراءة وكل من لا يستطيع القراءة ويسمع بهدوء وانتباه مناقب أم عراقية –
وأؤكد عراقية – حيث " يسرد " الشاعر سمات ومآثر هي سمات ومآثر أمهاتنا
جميعا، وهي خلاصة مركزة لمناقب أم اسمها فاطمة ( إسم أم الناقد ) والسماوة
والعراق، ولكن ليس سدني واستراليا قطعا ؛ أم عراقية جلدها مطرّز بالشذر ؛
جلد يتلون بألوان الطبيعة لكثرة تماهيها معها، فهي أمها وابنتها، كما أن
دمها يصطبغ بصبغة واقعها المرير المعيش، واقع خسارات العراق الباهضة، فالأم
العراقية هي عبر تاريخ هذي الأرض، مصدر حضاراتها، وسرّ ديمومتها. كلّ
الأفكار الأولى في أي حضارة جاءت من المرأة / الأم، وكلّ الإسهامات التي
يقدمها الرجل لحركة البشرية تأتي من أفكار يوحي بها الحضور الأنثوي الأمومي
الآسر: ( جلدها المطرّز بالشذر.. لا تجري تحته قطرة دم زرقاء.. قد يكون لون
دمها أحمر.. لكثرة ما شاهدت.. من دم على الأرصفة.. وأخضر.. لكثرة ما حملت
من عشب..
وأصفر.. لكثرة ما طحنت من سنابل.. وخبزت من خبز.. وأسود..
لكثرة ما حدّقت في ظلام العراق – ص 30 ).
هذه الصبور كانت ومازالت عبر تاريخها ضمانة حاضر العراق ومستقبله، ولوأريد
للعراق المحطم الآن، والذي مزق نسيجه الاجتماعي شرّ ممزق، أن يستعيد
عافيته، فإن المفتاح الأول لتحقيق ذلك يتمثل في إعادة الإعتبار إلى الأم
كإله غير متوّج. فعلى خطوط وجه أي أم عراقية تستطيع قراءة مسارات محن هذا
الوطن، وفي تلافيف عباءتها السوداء ترتسم انكساراته وصور محنه وخذلانه: (
عباءتها الشديدة السواد.. وحدها اللائقة علما لبلادي.. فيها كلّ تفاصيل
الوطن – ص 33 ). لقد كانت عفّة ذاك الجيل من الأمهات – ومنهن أم الشاعر –
مطابقة لعفة نبي وزهد قدّيس وترفّع متصوف. لم يكنّ يعرفن سوى محبة
أولادهن.. والإخلاص لدورهن كأمهات حاميات حد الفناء.. كنّ في بذلهن طبيعة..
نعم طبيعة مقهورة لكنها معطاء ومتسامحة ولا تردّ أحدا، هل رأيت شجرة سدر
تردّ طالبا جائعا؟ هل عرفت نخلة يهزها محروم وتتمنع عليه بثمرها؟. لقد خلقت
أم يحيى لتعطي.. ولتعطي بلا توقف حتى الموت: ( ذات شتاء.. والجوع يمصّ
دمنا: طرق بابنا سائل.. أعطته حزمة حطب.. وصحنا من الدعاء الجميل – ص 31 ).
وهذه ليست فذلكة شعرية، إنما هي واقع مؤصل ؛ صفة سلوكية
راسخة في سلوك الأم العراقية، ففي ظل سنوات الحرمان والعوز تلك كانت لدى
الأمهات، بل كل العراقيين فلسفة في العطاء، فلسفة الفقير في العطاء دين
كامل ويوتوبيا غير مفهومة من قبل الفلاسفة المتمنطقين الذين يندهشون حين
يرون الفقير يترك باب بيته مفتوحا، في حين أن كل قطعة فيه مهما كانت تافهة
هي في أهمية أغلى مقتنيات أي ثري مرفّه حد التخمة.. فأولا من أين يأتي
ببديل عنها لوسرقت؟ وثانيا – وهوالأهم – فإن كل قطعة تافهة لم يحتفظ بها
إلا لأنها تمد في بقائه.. أي أن السرير.. والغطاء..
وكوز الزيت.. والفانوس.. هي مسألة ترتبط ولوبدرجات متفاوتة
بمسألة الحياة والموت. فكيف تعطي الأم المحاصرة بالحاجة المذلة؟؟ أمهاتنا
سيدات فلسفة العطاء.. هنا فلسفة كاملة في النظر إلى " قيمة " الشيء المادي
الذي يصبح الثري الجشع عبدا له:
( سواء أكانت
داخل البيت أم خارجه.. تترك الباب مفتوحا.. رغم أن الذئاب.. لم تتخلّ عن
أنيابها.. ليس لأن أثاث البيت.. لا يساوي سعر القفل.. إنما.. لأنها تؤمن:
أن العسس هم اللصوص... في الوطن المخلّع الأبواب – ص 31 ). أي أن عطاءها
الغامر والمضحي يُمتحن في وطن يأكل آلهته.. ويكلل جباهها بالرماد.. فيضاعف
من عذابها.. لقد عوملت عند مماتها كإله مخلوع في أفضل الأحوال.. إن لم يكن
أسوأ من ذلك وابنها المثكول يتفرج منكسرا من بعيد.. بعيد.. بعيد.. على
الكيفية المتصوّرة شعريا وفعليا التي احتفى بها محبوها الفقراء بنقل
جثمانها إلى مستقره الأخير.. كانت محاطة بمخلفات الحروب التي اصطنعها من
كانت تمقتهم: الطغاة، اليتامى.. وشقيق معاق بساق اصطناعية.. وشقيقتان
أرملتان.. كانت تكره الطغاة بالفطرة.. بسليقة الأمومة.. فلا أم تحب
الحروب.. بل لا امرأة أبدا.. كيف ترضى أم أن يُقتل أولادها؟؟ والأم إذ تكره
الطغاة فإنها تحيا معادلة غريبة هي أنها عبدة لمحبة أبنائها.. وخادمة
لنمائهم.. ثم أن أولئك الطغاة الذين تكرههم لم يوغلوا في تحطيم توأمها..
الطبيعة.. الأرض.. الوطن حسب، بل شرّدوا ابنها يحيى إلى الأبد.. حدّ
موتها.. وأكثر هؤلاء الطغاة سفالة تحمل نعوشهم العربات وتُعزف لهم المارشات
وتطلق من أجلهم إطلاقات المدافع ؛هم المتخصصون بالحروب التي تلتهم الأبناء،
في حين يُحمل نعش الأم على سيارة أجرة في جنازة يتيمة كسيرة ؛ هي المتخصصة
في صنع السلام الذي تترعرع في ظله الحياة والآمال والأبناء:
( لم تحمل نعشها عربة مدفع.. ولم يُعزف لها مارش جنائزي..
القروية أمّي.. لا تحب سماع دوي المدافع.. ليس لأنه يُفزع.. عصافير نخلة
بيتنا.. إنما.. لأنه يذكّرها بـ " جعجعة القادة ".. الذين أضاعوا الوطن..
وشرّدوني.. تكره أصوات الطبول.. (باستثناء طبل المسحراتي ).. نعشها حملته
سيارة أجرة.. وشيّعتها: عيون الفقراء.. العصافير.. ويتامى كثيرون.. يتقدمهم
شقيقي بطرفه الإصطناعية.. وشقيقتاي الأرملتان... وجدولان من دموعي – ص 10
و11 ).
جمهور الأم الراحلة المعزّي هوالفقراء أولا.. هؤلاء هم الذين يعرفون قيمة
الأمومة الحقيقية.. الحرمان من الأم هوالفقر الأكبر. هؤلاء ترتبط ذكرى
الدور الأمومي لديهم بالحرمان فيتدعم المضمون الإنقاذي للحضور الأمومي، لكن
الرفاه والتخمة الطفلية المادية تضعف هذا البعد: ( آه... من لملايين
الفقراء... المرضى.. المشردين... وكل من كانت الطيبة أمّي.. تطعمهم كلّ
يوم.. خبزا دافئا من تنور دعائها... بعد كلّ صلاة؟ - ص 27و28 ).
أما القسم الثاني من المشيعين الذي لا يقل أهمية وغرابة
فهوالعصافير. وليس عبثا أن تتكرر ثيمة تعلق الأم بالعصافير وتعلق العصافير
بها لأنها الأكثر إيحاء من الناحية الدلالية اللاشعورية.. فالابن المثكول،
ومهما كانت درجة رشده، يبقى محتفظا بذاك الطفل / العصفور الذي كانه.. وما
زواجنا وإنجابنا إلا محاولة لاستعادة تلك العناية التي كنا نتمناها في
طفولتنا كعصافير مغدورة.. عناية يفرضها الطفل الذي لم يشبع من ذاك الثدي
المنعم المطعم.. وهولن يشبع نفسيا من موضوع الحب الأول أبدا.. أبدا..
وسيبقى هذا الحرمان المستديم متمظهرا في ما نسميه النرجسية الجريحة التي ما
هي إلا تكوين ضدّي.. وسيبقى ضاغطا يدفع الإبن إلى الإيمان بأكثر الطرق
سحرية - تصوّر بعدي لأفعال سابقة – حول فعل الأمومة.. وأعتقد أن الأم
الأولى هي التي ابتكرت " علم " السحر قبل آلاف السنين وهي راكعة قرب مهد
وحيدها المريض.. ثم تسلّم الذكور " علمها " آنذاك فأساءوا استخدامه مثل كل
منجز عشتاري وقع بين أيديهم الماكرة.. والشاعر يحيلنا إلى تحليل فريد
لعملية مماهاة الأم بالطبيعة.. فمن الخطأ مثلا القول أن الفعل الإخصابي
للأم مأخوذ من الأفعال الإخصابية للطبيعة.. هذه خطيئة تحليلية كبرى
عالجناها في مخطوطة كتابنا " تحليل أسطورة الإله القتيل ".. فمن جسد الأم
أخُذت الأطر التفسيرية والمصطلحات الرمزية لتأويل أفعال الطبيعة الإخصابية
وليس العكس ؛ لم ينتظر الإنسان الأول رؤية المطر الهاطل من السماء يعانق
الأرض ويخترقها ويخصبها كي يشرع بعمله الجنسي ويمنحه رمزيته، ولم تنتظر
الأم الأولى رؤية حبة القمح وكيف تنغرز في رحم التربة وتنمولتسم الإله
الإبن بإنه الإله القمح. لقد أسقطت معاني فعلها الإخصابي على الطبيعة.. على
دورة القمح.. وكفرضية: أليس تصميم الوظائفية الأمومية الإخصابية ( استقبال
البذرة الذكورية في تربة الرحم الأمومي ورعايتها إلى نبتة / جنين، فوليد،
يهيؤها عقليا ونفسيا لاختراع وابتكار الزراعة؟؟.. لكن ليس من أفعال الخصب
العشتارية أن دعاء الأم يفك حبل المشنقة عن رقبة الإبن.. هذا دعاء أم يحيى
الذي أنسنه وشخصنه الشاعر: ( دفء أمومتها.. وليس حطب موقدنا الطيني... أذاب
جليد الوحشة.. في شتات عمري.. رائحة يديها... وليس نوع الحنطة... جعل
خبزها.. ألذّ خبز... في الدنيا...
دعاؤها... وليس الحظ... أبعد الحبل عن رقبتي – ص 24 و25 ).
لم تكتفِ هذه
الأم العظيمة بأن تلد الشاعر وتمنحه أسباب الحياة مرة مثلما يحصل لأي واحد
منّا.. لكنها منحته امتيازا ثانيا مضافا واستثنائيا.. فقد أنقذته من الموت
الفعلي.. الموت شنقا.. وبذلك ولدته مرة ثانية.. وهكذا يكون الشاعر من
القلائل الذين يولدون مرّتين !!. هوعصفورها الذي منحته عمرين متجددين..
الأمومة ثابتة والأبوة متغيّرة.. مهنة الأمومة الرعاية والعطف سواء أكان ما
يقع بين يديها إبنا وحبة قمح وسنبلة وعصفورا.. كلّهم أبنائي شعار الأمومة
وليس الأبوة.. وأبناء الأمومة كل مكونات الطبيعة.. خصوصا الصغيرة /
العصفورية منها التي بحاجة إلى العون والرعاية: ( حين أزور أمّي... سأنثر
على قبرها... قمحا كثيرا... أمي تحب العصافير... كلّ فجر: تستيقظ على
سقسقاتها... ومن ماء وضوئها.. كانت أمي.. تملأ الإناء الفخّار قرب نخلة
البيت.. تنثر قمحا وذرة صفراء... وحين تطبخ رزّا... فللعصافير حصتها... من
مائدة أمي – ص 19 ). وحتى بعد موتها، فإن هذه الام العظيمة تبقى مهمومة
بمصير العصافير الهشة المسكينة وهي تواجه شظايا الحروب والإرهاب الباشطة
بأجسادها الصغيرة:
( الطيّبة أمّي.. ما عادت تخاف الموت.. لكنها... تخاف على
العصافير... من الشظايا...
وعلى بخور المحراب... من دخان الحرائق... والأمهات
اللائي... أنضب الرعب أثداءهن – ص 18 و19 ).
وهذه لعمري
مداورة نفسية ماكرة من العصفور المستديم الذي أصبح شاعرا وفقد الآن خيمته
الحمايوية التي كانت غيمتها تزخ في أعماقه أمطار العافية والأمن رغم بعده
عنها. والعناية التي قدمتها الأم الحنون للعصافير في حياتها، ثم انهمامها
بها بعد موتها، هوالأنموذج المرغوب اللائب في دواخل الإبن وقد أصبح أبا.
ففي رثائه لها يسلك مسارات " مصلحية " نفسية تحت أستار الالتحام بفجيعتها..
التحام مابعدي.. فهوإذ يعرف سحريا وشعريا – لا فرق – مدى انشغال الأم وهي
في قبرها بحال العصافير المسكينة وهي تواجه الشظايا التي لا ترحم، فإنه
يمرّر مماهاته نفسه بها.. بهذه الكائنات العزلاء.. مثلما يتشكل هدف ندائه
الباطن.. نداء زاجر ونافد الصبر يحرص على مصلحة الأم بعد موتها: ( وأنتم
أيها الهمجيون... من متحزّمين بالديناميت... وسائقي سيّارات مفخّخة.. وحملة
سواطير وخناجر... كفى دويّ انفجارات وصخبا... الطيّبة أمّي لا تطيق
الضجيج... فدعوها تنام رجاء – ص 18 ). ولولاحظنا مفارقة الطلب الملتمس
الختامي من مجرمين قتلة بعد بداية صارمة شديدة الحزم.. فسوف نتأكد من
انكشاف النكوص العصفوري إذا جاز الوصف الذي ظهر حييا ومغيّبا تحت أردية
الشعر الخلّابة الكفيلة بتغييب انتباهتنا النقدية، ويساعد على ذلك تماهينا
مع الشاعر المثكول، فلا موضوع مثل خسارة الأم يمكن أن يثير تعاطفنا ويستفز
قلق الخسران الكامن بما يرتبط به من مشاعر أمان.. والأهم ذكريات طفلية تبقى
هي الصورة المثلى لحياة اعتمادية رخيّة تمثل الأنموذج المكافئ الأمثل
للحياة الرحمية الفردوسية.. حياة اجترها الشاعر من مخزون أحشاء ذاكرته..
اجترها لأن لاشعوره يرفض هضمها والخلاص منها نهائيا فهي من مقومات وجوده
الظلامي الباذخ.. هذه الحياة عبّر عنها الشاعر ببلاغة تفصيلية تهيج جراحات
تثبيتنا التي ندّعي الإبلال منها تنفجا:
( في صغري... تأخذني معها إلى السوق... وبيوت جيراننا...
حتى وأنا في مقتبل الحزن... لا تسافر أمّي إلى كربلاء... إلا وتأخذني
معها... أنا عكازها... وفانوسها... وحامل صرّتها المليئة... بخبز العباس...
والبيض المسلوق... وإبريق شاي الزهرة... فكيف سافرت وحدها للقاء الله؟؟...
ربّما... تستحي من ذنوبي !... آه.. من أين لي بأم مثلها... تغسلني من وحل
ذنوبي... بكوثر دعائها... حين تفترش سجّادة الصلاة؟؟ - ص 20 و21 ).
وهوفي مرحلته
الراشدة الآن، وضمن سياق حداد ذاكرته الإستعادي يسترجع بعقلية تفسيرية "
بعدية " حتى اللمحات الطفلية الغائرة في عمر الزمن، ليمنحها بعدا إدراكيا
مكفّرا يتكفل الشعر بإخراجه، وتشكل هذه الاستعادة جزء من عملية تفريج غمة
الإحساس بالإثم: ( يوم صفعتني.. بكيت كثيرا.. ليس لأن الدم.. أفزع الطفل
النائم في قلبي.. ولكن: خشية أن يكون وجهي الفتي... آلم كف أمّي – ص 25 ).
وهذه الإستعادات الذاكراتية الآسية تمرّر تحت غطاء الحداد،
الإحتفاء الحسّي بجسد الأم، كطبيعة مصغّرة الآن، لكنها طبيعة ذات طبع خارق،
تجتذب النحل بالإيهام وتتسامح مع لسعاته. هي حقل متنقل.. بستان البيت الذي
يغوي الفراشات بالإقامة الدائمة، لذلك نصف الأنوثة دائما بأنها " الإنسان
ضمن الطبيعة –
humanbeing among
nature
"، في حين نصف الذكورة بأنها " الإنسان ضد الطبيعة –
humanbeing
against nature
": ( مرّة.. لسعت نحلة جيد أمّي... ربما.. ظنت نقوش جيدها ورودا زرقاء..
لتصنع من رحيقها عسلا.. خضرة عينيها... أغوت الفراشات للإقامة.. في بيتنا
الطيني – ص 26 ). التساؤل السابق عن أن الأم المختطفة من قبل أخّاذ الأرواح
/ ملك الموت قد سافرت وحدها للقاء الله لأنها تستحي من ذنوب الإبن، هوجزء
من تخريجات تحاول يائسة التخفّف من الشعور بالهجران والإنخذال، فلابد من أن
" يعقلن " الإبن عملية الإنثكال بأعز ما لديه والتي جرّده فيها المثكل من
أية علامة اقتدار على الفعل الإنقاذي المتخيّل.. وبالمناسبة فإن " مقلوب "
هذا النزوع اللائب في اللاشعور، هوالذي دفع مؤرخي الأساطير إلى اعتبار
دموزي / الإله الإبن منقذا، وهوالذي جعل أكثر الشعوب تحتفي بالإله الإبن
المنقذ، في حين أن الإنصاف التحليلي العلمي يفرض، وبلا لبس، الإحتفاء
بالإلهة عشتار كمنقذ.. المخلّص بالنسبة للإبن ليس المسيح والمنتظر، بل
الأم.. ويتساوى بالنسبة للشاعر دورها الإنقاذي قبل وبعد الموت، فـ: ( قبل
فراقها: كنت حيّا... محكوما بالموت.. بعد فراقها: صرت ميتا... محكوما
بالحياة – ص 8 ).
إنها القادر الذي يستطيع قلب معادلات حياة الابن حتى لوكان
ميتا. وذلك لأن النزعة الخلودية تتأسس على قوى اللاشعور الذي لا يقر
بالفناء أبدا، والذي يتجاوز في فعله أطر الزمان وتحديدات المكان، ولا محل
للغرابة من التناقضات التي تسود بين مكوناته، بل إن التضاد من سماته، وفي
عوالمه تطفومنعمة صورة الأم المنقذة العصية عن الفناء، ومنها تشتق كل
النزعات الباحثة عن الخلود في نفس الإبن كجهد مواز للديمومة الأبدية التي
يترعرع في أحضانها موضوع الحب. ولذا وحتى بعد موت هذا الموضوع فإنه يفنى في
الخارج في حين يمضي مفعما بالحياة في الداخل، يرعى الإبن المثكول ويحرص
عليه عبر هذا الرباط السري الذي لا يعرفه سوى لاشعور الإبن:
( مذ ماتت
الطيبة أمي... لم أعد أخاف عليها... من الموت... لكنها بالتأكيد... تخاف
الآن عليّ.. من الحياة – ص 22 ). والشاعر يعبّر عن هذه المعادلة المربكة
بصورة مقتدرة والتفافية أعدها من نفائس التعبيرات الأدبية التوروية عن
قواعد عمل اللاشعور، الذي يحوّل موضوع الحب الأثير الحاكم في حالة فنائه من
الوجود الخارجي العابر، إلى المستقر الخلودي في الوجود اللاواعي الداخلي،
ألم يقل معلم فيينا أن الشعراء أساتذتي؟؟ وبهذا وحده نفسّر سبب عدم خوف
الشاعر على أمّه من الموت بعد موتها، فإذا قررنا أن ذلك ينبع من ثقته أنها
رحلت مرة واحدة وإلى الأبد نكون كمن يفسّر الماء بالماء ويقدم فهما بالغ
السذاجة لا يكافئ الناحية النفسية الإقتصادية من جهد الشاعر: ( اليوم..
سقطت حفنة أوراق.. من شجرة مخاوفي: أمي لن تمرض بعد الآن.. لن تشقيها
غربتي... لن ترعبها أسئلة الشرطة عني... وأنا... منذ اليوم: لن أخاف عليها
من الموت... أبدا – ص 27 ).
وهذا تقرير حال مدمّر قد يجعل القاريء المأخوذ بالفجيعة
المشتركة يعتقد أن هذا الوضع الشائك الملتبس قد خلقه حال يحيى المنفي
المعذّب وهويرى من أقاصي الدنيا ضياع منقذه من دون أن يقوى على أي درجة من
الفعل الإنقاذي الذي ألصق به عبر التاريخ.. أين دموزي وحركاته الإنقاذية
الخارقة؟؟.. لقد سحبته خنازير العالم الأسفل بلا رحمة وكان يبكي ويتوسل
بأخته / بديل أمه أن تنقذه وتخلّصه من شياطين ( إريشكيجالا ) التي قطعته
إربا ودقّت المسامير في أطرافه ( تتكرر حكاية المسامير مع المسيح !! ). لكن
السماوي لا يتردّد في وضع النقاط على حروفها النفسية ويعلن بلا تردّد عن
أنه كسير محطم بحاجة للإنقاذ من أعظم قوة إنقاذ في الوجود.. هكذا رسم
صورتها اللاشعور حتى لوكان لاشعور شاعر مهم وأب لأربعة أبناء:
( لماذا
رحلت؟... قبل أن تلديني يا أمي... أدريك تحبين الله... ولكن: أما من سلالم
غير الموت... للصعود إلى الملكوت؟ - ص 9 ). وتحت أردية الخطاب المعاتب للأم
في رحيلها " الغادر " الغير مبرّر بالنسبة للإبن حتى لوكان من أجل ملاقاة
الله.. تُمرّر الحفزات التحرّشية التي تحفظ للشعر بهاءه الأقصى... ويبدأ
التحرّش دائما بالتساؤلات التضحيوية المفروغ منها.. وهي أشد أشكاله لؤما..
فالإعتراض الذي يأخذ شكل تساؤل " بريء " عن سرّ الحكمة التي تقف وراء خطف
الفقيد تشبه، حين تلبس لبوس الشعر الاستعاري على يدي يحيى، صرخة الام
المعاتبة الجارحة التي فقدت ولدها: " ليش أخذته؟؟ ". لكن التعبير الشعري
كفيل بتمرير هذه الحفزة الإتهامية التي تلامس سويداء المعصية المختلجة في
نفوسنا حين نتخيل فقدان أمهاتنا بلا سبب مبرّر، فقدان يشكل الحركة
التمهيدية في لعبة شطرنج الحياة والموت التي تهيؤنا لتوضيب حاجيات الرحيل:
( سبحانك يا رب !!... أحقا أن عذاب جهنم... أشدّ قسوة من
عذابي... حين تعذّر علي... توديع أمّي؟؟... آه.. لوأن ساعي بريد الآخرة...
وضع الرسالة في صندوق عمري... لا على وسادة أمّي – ص 14 ).
ثم تتحول الحفزة التحرّشية المتسائلة في المظهر، والناقمة
في الجوهر، إلى نقمة معلنة لكن محبّبة تحت أستار الأسى السوداء، يحاسب
الإبن الشاعر الأم الفقيدة عن سبب خذلانها إياه، وباحتجاج طفلي هادر لا يرى
الإبن المنهجر مبررا لوضعه المظلم هذا، حتى لوكان السبب بلوغ الأم الراحلة
الفردوس بحاله. إن الإنهجار الذي يصحي القلق المكبوت القديم.. قلق الإنفصال
علميا.. وقلق الإنهجار فنّيا.. لا.. بل يفجّره كما هوالأمر مع يحيى..
تفجيرا يخلق غلالة غضب تحجب حتى أبسط الحقائق اللاهوتية عن عيني بصيرة
الوعي، ولكن بصيرة اللاشعور اللعوب التي تعرف كيف ومن أين تأكل كتف اللذة
حتى لوكانت في جحيم الثكلان تستعين بمآثر الفقيدة:
( لم تكن أمي
أنانية يوما... فلماذا ذهبت إلى الجنة وحدها؟... وتركتني في جحيم الحياة؟؟
- ص 22 ).
إن هذه التساؤلات شبه الإنكارية تحيلنا إلى أمر مهم يتعلق
بما قلناه عن إنكار اللاشعور لفنائه الشخصي واعترافه بفناء الآخرين، والذي
عبر عنه معلم فيينا بدقة قائلا: ( إن الإنسان منذ القدم اتخذ موقفا متميزا
للغاية إزاء الموت. فهومن ناحية كان يأخذ الموت مأخذ الجد ويدركه باعتباره
ختاما للحياة وكان يستخدمه لهذه الغاية، ومن ناحية أخرى فإنه كان ينكر
الموت ويرده إلى عدم. وقد نشأ هذا التناقض عن الظرف الذي جعله يتخذ موقفا
تجاه موت إنسان آخر، أي موت إنسان غريب، يختلف اختلافا جذريا عن موقفه إزاء
موته هونفسه. لم يكن لديه اعتراض على موت الإنسان الآخر: فقد كان يعني فناء
مخلوق مكروه، ولم يكن لديه أي تردد في إحداث هذا الموت. فقد كان – في
الحقيقة – كائنا بالغ العنف، أشد قسوة وأكثر إيذاء من الحيوانات الأخرى.
كان يجب أن يقتل، وقد كان يقتل بطبيعة الحال، ولا حاجة بنا لأن ننسب إليه
تلك الغريزة التي يُقال أنها تكبح جماح الحيوانات الأخرى عن قتل وافتراس
الحيوانات من نوعها (... ) لقد كان موت الإنسان القديم بالنسبة إليه هونفسه
أمرا لا يمكن تخيّله وغير حقيقي تماما، كما هوبالنسبة لأي منا اليوم. ولكن
كانت هناك بالنسبة إليه حالة يتصارع فيها الموقفان المتعارضان تجاه الموت،
وكانت هذه الحالة بالغة الخطورة وتسفر عن نتائج بعيدة الأثر، وكانت تحدث
حينما يرى الإنسان البدائي شخصا يمت إليه بصلة – زوجته، ابنه، صديقه، وهم
الذين كان يحبهم بالتأكيد كما نحب نحن ذوينا. ذلك لأن الحب لا يمكن أن يكون
أصغر كثيرا من الشهوة إلى القتل. عندئذ فإنه – في لحظات ألمه – كان عليه أن
يتعلم أن المرء نفسه يمكن أن يموت، وهواعتراف كان كيانه كله يتمرد عليه،
ذلك أن كل واحد من أولئك الأحباء إليه كان – بكل صدق – جزءا من ( أناه )
المحبوب. ولكن – حتى رغم هذا – فإن حوادث الموت هذه – من ناحية أخرى – كانت
لها مصداقية بالنسبة إليه، حيث أن شيئا ما من الغريب المعادي كان يقيم داخل
كل من هؤلاء الأشخاص الأحباء ) **. وهذا الإقتباس الطويل نسبيا في غاية
الخطورة، لأنه يكشف الأسباب الخفية التي تجعلنا لا نفكر بموتنا الشخصي رغم
أننا نشاهد الآلاف من البشر يموتون يوميا. هذا كان حال جلجامش الذي كان
يقتل الكثيرين كل يوم حتى اشتكى منه العباد إلى الآلهة، ولم يكن يفكر
بالمثكل لحظة واحدة. حالة استثنائية يصحوفيها اللاشعور من غيبوبة سكرة
الخلود ليصدم بيقظة فكرة الفناء هي عندما يموت عزيز استدخله في لاشعوره،
فعند موت هذا العزيز ينخلع جزء من اللاشعور الشخصي، هذا ما حصل لجلجامش بعد
موت أنكيدو، وهي الهزة الوجودية المرعبة نفسها التي أصابت كيان يحيى
السماوي برحيل أمه، مع فارق أن حال السماوي أشد مرارة وخيبة، فالأول مات
خله وصاحبه بين يديه، والثاني ماتت أمه وهوفي المنافي، وبعد فراق عقدين.
هذا الانخلاع القسري الذي سببه موت محبوب، لا يمكن أن يسلم به اللاشعور
فورا وبلا مقاومة، لأن هذا التسليم يعني الإقرار الفوري بهشاشته الوجودية
وبقابليته على الإنجراح. ولذلك لابد من أن يتم هذا التسليم – كآلية نفسية
دفاعية
defence mechanism
- على مراحل تبدأ أولا بالإنكار –
denial
القاطع: مستحيل
لا يمكن أن تموت أمّي: ( الطيبة أمّي لم تمت... لازالت... على قيد دموعي –
ص 24 ). ثم – وحين يدرك الشاعر أنه أينما يولّي وجهه فثمة وجه الموت: الحي
الذي لا يموت – يأتي الإقرار المُذعن الذي لا تنفع معه التزويقات التخديرية
الشعرية السحرية. في البداية يبقى رجاء مختلج حيث يخاطب الإبن أمه على "
أمل " بصحوة مستحيلة: ( أرجوك استيقظي لحظة يا أمي.. لأقول لك... تُصبحين
على جنّة – ص 33 ).
وصيغة المخاطب – الضمير الثاني – تنطوي في مضامينها النفسية
المخاتلة على معاني الديمومة والإنتصار على الموت، لأن اللغة بأكملها هي
أعظم الأدوات التي اخترعها الإنسان في مقاومته المستميتة لقدر الفناء
ومناجله الباشطة. هذا ما لم ينتبه إليه أحد سابقا. ولتوسيعه أقول إن كل ما
أنجزه الإنسان ينبع أصلا من مخاوفنا الطفلية تجاه محنة "التلاشي".. أين
تختفي الأشياء، وهي المحنة التي يتشارك فيها الطفل البشري في أي عصر مع
الإنسان البدائي الذي حيّره " اختفاء " الأشياء وتلاشيها. فابتكر الحضارة
كدفاع أصيل ضد محنة التلاشي، ولهذا حديث طويل ليس هنا مجاله. المهم أن ضمير
المخاطب هوتعبير عن محاولة للإنتصار على الموت، من خلال السعي لاستحضار
الغائب:
( يا أمي..
طفلك الكهل... لم يجد مأوى أيتام... يودع فيه أحلامه – ص 32 ). ثم نتقدم
خطوة انتقالية على طريق الإقرار المستخذي حين يبقى بصيص خطاب يوهم به
الشاعر نفسه بما حصل بعد عملية الدفن الجائرة وفق كل المعايير النفسية
المختزنة التي لا ينفع معها حتى تبرير إله. فقد " تآمر " الإخوة، وفق نظرة
الإبن المنهجر على أن يغطوا جثمان الأم بطبقات هائلة من التراب وهي في
قبرها، كي لا تسمع نداءات الإبن الجريحة، ذئب البوادي الإسترالي المطعون
والمتروك في برية الوحدة واليأس، أي أن رجفة أمل لائبة مازالت تتحشرج في
أعماقه المخربة في أن تسمع أمه نداءه وهي في غيابة القبر. وهوحين يحاول
تبرير تساؤله وتمريره، من خلال اللعب على حقيقة أن فصل البرد السنوي لم يكن
قائما حين ارتحلت أمه في عربة قطار الموت السريع في السماوة، فلا حاجة لها
بدثار خانق وثقيل من التراب، إلا إذا كان الإخوة القابيليون يبغون عدم
إيصال نداءاته المفزعة إليها، فإنه يبقى لاعبا أصيلا داخل مضمار لعبة
الإنكار وتعطيل الرضوخ النهائي: ( الفصل ليس شتاء... فلماذا غطّاها
أشقائي... بكل هذه الأغطية من التراب؟.... ربما... كي لا تسمع نحيبي...
وأنا أصرخ في براري الغربة – ص 15 ).
لكن هذا القهّار الرافع الخافض المعز المذل المسمى الموت، صاحب الأسماء
الحسنى، الذي هوآخر ملاذات الآلهة المحاصرة والتي يحاول شياطين العلم
وأبالسة الاستنساخ الوراثي تجريدها من ورقة توت قبض الأرواح الأخيرة التي
تتمترس بها، وهي فعليا آخر امتيازاتها في عصر أعاجيب الثورة العلمية الحاكم
الآن، لا يوجد مصل تخديري يواجهه غير الشعر ( ألهذا تحذّر الآلهة من
الشعراء لأنهم يكشفون أسرار الخديعة؟ )، ولهذا يوهمنا الشاعر وهوينحدر
بقساوة على منحدر التسليم المسنن لكي يستقر عند سفح التسليم الفاضح
المنخذل، بأن من الممكن إسداء العون له من فرد عابر يلتقط له صورا متعددة،
منها واحدة تظهر أمّه الغالية نائمة في قلبه، كطفل صغير يحتويها ببراءة
كأنه يعيد – سحريا – كرّة الحمل المبارك به:
( أيّها
العابر... لحظة من فضلك.. هلّا التقطت لي... صورة تذكارية مع الهواء؟..
وأخرى مع نفسي؟.. وثالثة عائلية.. مع الحزن والوجع الوحشي... وأمي
النائمة... في قلبي؟ - ص 13 ). لكن هذه المحاولات كلها هي نقلات حييّة
لكنها هائلة على مستوى الإنجراح الإنساني النفسي المستديم، وسوف تتكلل
بالإذعان الراضخ الذي لا عودة منه. وستشهد أرض المنفى- بعد طول ممانعة -
أول خطوة في هذا السبيل المستخذي، في المأتم الذي سيقيمه الأصدقاء الذين
لابد أنهم يرون في انثكال الشاعر مصيرهم المقبل، فالمنفيون والمهاجرون هم "
رفاق الزورق الواحد " كما يصفهم علماء نفس الهجرة، ورحيل أم يحيى في
السماوة وابنها غريب في المنافي يعني رحيل أم كل واحد منهم بالطريقة نفسها،
إن لم تكن أكثر سوءا وإيلاما. لكن هذا التشارك الشخصي في " شكل " الكارثة
لا يغني عن الإختلاف المحتم في " مضمونها " بفعل الفروقات الفردية في
التجربة. فقد أعد الأصدقاء في " أديليد " كل شيء للعزاء، ولم يستطيعوا
الإعداد لشيء حاسم نسوه والشاعر بأمس الحاجة إليه وهوتوفير الكمية المناسبة
من الدمع:
( في أسواق " أديليد "... وجد أصدقائي الطيبون.. كلّ
مستلزمات مجلس العزاء: قماش أسود.. آيات قرآنية للجدران.. قهوة عربية..
دلال وفناجين...
بخور وماء ورد.. باستثناء شيء واحد: كأس من الدموع..
ولوبالإيجار... أعيد به الرطوبة.. إلى طين عينيّ.. الموشكتين... على الجفاف
– ص 8 و9 ).
إنه مرتبك بفعل
الخسارة الجسيمة.. خسارة مزدوجة.. خسارة أم.. وخسارة وطن.. وكلاهما تابوتان
يحملهما على ظهره المحني.. هما ثقلان هائلان يجعلان من أمر سقوطه تحت أي
مؤثر مبتذل: ورقة وقطرة ماء ( وهما اللذان سيجمعهما في مقاطع مقبلة بتعبير
رمزي بليغ: الورقة الموت قابلة للإحتراق والفناء، والماء الخلود قادر على
الإطفاء والديمومة: أغيثوني: أريد أوراقا من ماء... لأكتب.. كلمات... من
جمر ) أمرا يسيرا لا غرابة منه. لكن المشكلة تتمثل في أن النظّارة باردي
المشاعر.. من غير أهل السماوة.. ومن أهلها وقد بلّدت مشاعرهم المنافي
المقيتة.. على أساس قاعدة أمهاتنا الحكيمات: "البعيد عن العين، تسلاه
القلوب " لا يدركون سوى مظهر يحيى المتماسك، غافلين ومتغافلين عن فجيعته
المهلكة التي لا تلتقطها غير عين الداخل المتعاطفة. لكن مقدرتها لا تتوفر
لأي أحد. إنها هبة مفتقدة في المنافي.. تغطيها رمال اللاإكتراث التدريجي
بفعل العادة وخمول المشاعر تمهيدا لتبليدها، ولذا فالشاعر المثكول يُظلم من
قبل رفاقه فيظنون سقطته على الرصيف بفعل سكرة الخمرة المدوّخة، وليس بسبب
لطمة المثكل المرعبة التي جردته من أمه بعد أن خلعته من وطنه / الأم، أي
سلبته أمّين اثنتين: ( لست سكرانا.. فلماذا نظرتم إليَّ بازدراء... حين
سقطت على الرصيف؟.. من منكم لا ينزلق متدحرجا... حين تتعثر قدماه بورقة...
وبقطرة ماء.. إذا كان.. يحمل الوطن على ظهره... وعلى رأسه تابوت أمه؟ - ص
16 ).
ومن حركة المسامحة المعاتبة والمفترضة ذات الطابع الشفيف
هذه، وهي أصلا تمت بصلة لسوء فهم داخلي أكثر مما هوتعبير عن ربكة دلالية
خارجية تحتمها علاقات اجتماعية مفترضة نبتت في غير أوانها، ينكشف المسكوت
عنه في شخصية وسلوك الشاعر، وهوالمسكوت عنه الجمعي في شخصياتنا وسلوكنا،
مسكوت عنه يعبر عن مرعوبية إرادتنا واندحارها:
( مثل طفل
خطفوا دميته... أريد أمي... فتبكي !! – ص 16 ). وبهذا النكوص الطفلي لم يعد
لدى الشاعر ما يخفيه. كل شيء صار معدا للإنكشاف الفاضح.. وبعد أن كان يحيى
منخذلا بعدم فهم من يشاهدون ارتباكه وهوينزلق على قطرة ماء الخسران الرقيقة
بحجمه الهائل، نجده الآن يطلب الرحمة منهم.. لكن أية رحمة؟.. إنه لا يطلب
منهم خبزا ولا كوثرا ولا عافية !!. إنه يطلب منهم – بل يتوسل إليهم – ن
يمنحوه تجلّد بغل وبلادة خروف ولامبالاة حمار.. فهذه السمات المهينة /
العطايا هي الكفيلة بلحم أبضاعه الممزقة، وبعد هجمة الاحتجاج بفعل سوء
تفسير سقطته، من قبل أحبائه الطيبين، يتوسل بالأحباء أنفسهم بأن يعينوه على
امتلاك طاقات تعينه على مواجهة المثكل: ( يا أحبائي الطيبين... أرجوكم.. لا
تسألوا الله أن يملأ: صحني خبزا... وكوزي كوثرا... وجسدي عافية... وروحي
حبورا... فأنا بحاجة الآن إلى: صبر رمال الصحراء على العطش... وتجلّد بغل
جبلي... وبلادة خروف... ولا مبالاة حمار.. وإلى خيط من جنون... أرتق به
عقلي – 21و22 ).
وهولا يكتفي بطلب العون من إخوته وأحبائه الذين أساءوا فهمه
قبل قليل حين تعثر وهوالذي ينوء كاهله بتابوت مزدوج، لكنه – وبفعل ضغط
مشاعر التقصير الملتهبة – لا يكتفي بتقديم براءات التكفير من أمه بصورة
مباشرة، ولكنه يعمّم حالة التكفير الحارقة هذه على كل من ارتبط بعلاقة
وثيقة بهم من أصدقاء وطلبة ورفاق معتقلات و.. و.. ومجانين.. ليطلب الصفح
منهم عن شيء لم يقترف ذنبا منه، لكنها توريات اللاشعور الآثم المحصّن –
بخديعة الشعر – والمنطلق نحوحضن موضوع الحب / الأم.إنه " يودّع " في الواقع
فقد صار ما لا يُتخيّل حقيقة، معنى موت أمي هوأنني قابل للموت أيضا:
( يا كلّ الذين
أغضبتهم يوما... من أصدقاء طيبين... ومجانين... وباعة خضروات... وزملاء
طباشير... وطلبة رائعين أبعدتني الحكومة عنهم... ورفاق معتقلات ومعسكرات
لجوء... وأرصفة منافي: إبعثوا إلي بعناوينكم... وأرقام هواتفكم... فأنا
أريد أن أعتذر منكم... قبل ذهابي للنوم... في حضن أمّي – ص 17 ). وهذا
التوديع هوالمرحلة النفسية اللاحقة من عملية استقبال فكرة رحيل عزيز،
وتتمثل في الوقوع في شرك الإكتئاب والمزاج السوداوي، حيث النظرة الفارغة
إلى الحياة، وفقدان الرغبة في الأشياء والموجودات. هنا الجلسة المنكسرة
المنطوية على ذاتها، في محطة الحياة الأخيرة، منتظرا " غودو" الحياة الوفي
العظيم الذي لم يخذل أحدا أبدا: الموت. هنا حالة تصالح مع غربان المصير
الأسود التي لم تعد أصواتها ومجرد حضورها تثير التشاؤم. هنا يأتي القاتل
الأزلي ( والموت نوع من القتل كما يصفه المتنبي ) فيجد كلّ شيء مهيأً، لا
احتجاج، ولا رفض ولا إنكار ولا مقاومة.. بل على العكس مما يتوقعه، قد يّصاب
بالخيبة لأن الهدف / الضحية مات قبل أوان قبض روحه، وقد يتضاعف إحباطه حين
يجد الأخير ينتظره بفارغ الصبر، ومرتديا كفنه !!:
( يوم رحلت أمّي: جفّ حليب الطفولة في فمي... والزَبَد في
مفرقي.. لم يعد ملح السنين.. صار أولى خيوط كفني... مذ رحلت أمّي... وأنا:
جثة... تمشي على قدمين... في مقبرة... اسمها الحياة – ص 33و34 ).
إنها حالة من
اليأس القاتم الخانق التي تجعل الفرد يعيد مراجعة حسابات قلقه وهواجس
مخاوفه التي كانت قبلا ترعبه وتقض مضجعه. فبعد أن يستخف الإنسان بالموت
وينتظره بنفاد صبر، لا يعود لأي مصدر من مصادر القلق الأخرى أي معنى مهدّد.
فما الذي سيعنيه المرض والإنفصال والعوز والمنفى لشخص يشعر أنه جثة تمشي
على قدمين؟ حتى العمى الذي يمثل أقسى درجات الإنخصاء الوجودي والنفسي
الرمزي ( لهذا عاقب أوديب نفسه بفقء عينيه بأسياخ الحديد ) والذي كان مجرد
التفكير فيه يفزع الشاعر يوم كانت لعينيه قيمة مستلهمة من " إنطباقهما "
على صورة موضوع حبّه، لم يعد مصدر ذعر، فوق ذلك نجد الشاعر يتحدى العمى في
عقر وظيفته: ( أيها العمى... لن أخافك بعد اليوم... عيناي أصبحتا...
فائضتين عن الحاجة... تماما كالزائدة الدودية... مادمت لن أطبق بهما... على
وجه أمي – ص 28 ).
لكن الشاعر يبقى في دوامة مصيره المؤكد – وقد تأكد منه
تماما الآن – " يخطط " للكيفية التي يلتحم بها بالأم الحبيبة الراحلة. هنا
يوقظ اليوم الخيارات الإلحادية – نفض اليد من لعبة الحياة والموت ومن رحمة
السماء ودورها نهائيا – والإيمانية – التقرّب الذي قد يكون مبالغا فيه من
السماء، والغرق في الممارسات الدينية الطقوسية – على حدّ سواء. كلّ هذا
يعتمد على المآل النهائي الذي نتصوره لفقيدنا الغالي، هل سيأكله الدود
وينتهي كل شيء في حياة مادية متهالكة فيها النمل الأسود أعظم فعلا من
الإنسان - بناء الله وخليفته والمخلوق على صورته والذي يمزمز به دود القبور
!! -، أم أنه سيحيا مكرما في حياة ثانية تخيلناها كرد فعل دفاعي خلودي
وكثأر من مهانة أننا – في نهاية مصائرنا عبارة عن كيس لحم وعظام تافه قد
يلعب بها الأطفال في المقابر الدارسة ويضحك على نوعها الآثاريون في بحوثهم
بعد مائة عام !!. اختار الشاعر الخيار الإيماني، وهاهويهيئ نفسه بعد ما
يبدوأنه حياة لذائذ عاصفة، فيبدأ بخلع صاحباته الخطايا باحتقار كما يخلع
قميصه الوسخ، ليضمن الدخول إلى الفردوس.. فهناك سيرى الأمومة آلهة متوجة:
( أيتها
الحماقات.. اللذائذ.. النزق.. الطيش.. البطر.. الخطيئة... الجنوح...
المعصية: ها أنا أخلعكن من حياتي... كما أخلع قميصا وسخا... عليّ منذ
الآن... التوضؤ بالكوثر... كي يسمح لي الله.. بدخول فردوسه... لرؤية أمّي –
ص 14و15 ).
وقد تركت له أمه ما يوحي له بالطريق السديدة التي يجب عليه
أن يسلكها كي يلحق بها ويلتقيها في المكان الأخروي المطلوب.. تركت له –
بخلاف إبيه، " هدهد الآخرة " الذي لن يحضر أبدا، والذي ترك له فاتورة
كهرباء إرثا هزيلا مضنيا – تركت له عباءتها التي فوق أنها رمز الإحتضان
والتثبيت على حب الأم الذي لا خلاص منه، فهي إشارة فسّرها بأنها تحديد
للخيار الإيماني ؛ سيتخذها سجادة للصلاة.. وهويكاد يكون أكثر انكسارا من
أبيه.. فقد ورث بدلة ابنه الفقيد.. وسيورث أبناءه قائمة آماله المجهضة،
فإذا كانت أمه قد تركت له عباءة ورمزا وخيارا ودفنت في أرض وطنها، فإنه لن
يترك لأبنائه سوى غصات أمان لم ولن تتحقق، فقد صارت في هذا الزمن مستحيلة
على العراقي رغم بساطتها: وطن آمن وقبر سعيد:
( حين مات
أبي... ترك لي فاتورة كهرباء.. حين مات ولدي... ترك لي... بدلة العيد الذي
لم يعشه.. أمي؟.. تركت لي عباءتها... سأتخذ منها سجادة للصلاة... أما
أنا... فسأترك لأطفالي... قائمة طويلة... بأمنياتي التي لم تتحقق.. منها
مثلا: أن يكون لي وطن آمن و... قبر – ص 23 و24 ).
والآن هل نتوقف عند هذا الحد؟ ألم نشبع نص السماوي درسا
وتحليلا وكشوفا؟. كلا.. لن نتوقف.. وبالأحرى أن النص الكبير هوالذي يمسك
بتلابيب قدراتك التحليلية ويهزك ولا يتيح لك التوقف. إن وقوفنا عند هذا
الحد من التحليل رغم ثرائه سيغفل الجانب الآخر الذي لا يقل أهمية عن مضامين
ودلالات رثاء الأم المباشر. إن الجانب الذي سوف نتناوله هوالذي يضفي قيمة
كبرى على هذا النص. وهويتعلق بالتأملات الفلسفية والوجودية التي أثارها
رحيل الأم. هذه التأملات هي التي ينطلق فيها الشاعر مما هوشخصي، ومحدود
التأثير في دائرة الكينونة الفردية، إلى ما هوعام وكوني يلامس صميم معضلات
وجودنا كبشر. وهذه الوقفات ( المقاطع في هذه القصيدة ) تقابل ما أسميته بـ
" الفسح السردية التأملية " في الرواية، التي من دونها – ومن دون الحوارات
- لن يبقى من الرواية سوى الحكاية المجردة. وليس شرطا أن الإنثكال بعزيز
يرحل مثل الأم يؤدي إلى تحطيم أحبائه الأحياء. لقد كشف الشاعر بلا لبس
مقدار الألم الساحق الذي يعتصر روحه بفعل موت أمّه، وما تعنيه تلك الخسارة
لفقرائها وعصافيرها، ورسم صورة الأم الحنون المعطاء المتصالحة مع ذاتها ومع
الطبيعة والكون الصغير المحيط بها، الأمر الذي يضاعف من شعورنا
بجسامة الخسارة، كما صور الشاعر بصدق موجع الزلزلة التي
صعقت وجوده بفعل هذا الرحيل، وكيف تعاونت صدمة الفقدان مع ضغوط المنفى على
تمزيق إرادته وإيقاعه في فخ الإكتئاب واللامبالاة. لكن الموت يمكن أن يكون
فرصة لا تعوّض لإنضاج الشخصية وتطورها. يتم ذلك عبر الوقوف عند المضامين
العميقة للغز الموت، ولمعنى هذه اللعبة المسماة الحياة والموت في حركتها
التي لا تهدأ والتي تطحننا بين فكي الزمان:
( أيها
الناعور.. هلّا كففت عن دورانك... المطر جمر.. والأرض ورق – ص 32 ). حرائق
وجودنا، نحن الورق الهش لن يتوقف دخانها أبدا، تحت الوابل الأزلي لجمر مطر
الأقدار. وهي فعلا لعبة، لعبة مسمومة، مادمنا نعرف اللعب بأنه أي نشاط يهدف
إلى الحصول على المتعة. لعبة نحن موادها وأدواتها، أحياء وأموات.. وما
الفرق بين الأموات والأحياء؟: ( الأحياء ينامون فوق الأرض... الموتى ينامون
تحتها.. الفرق بينهم: مكان السرير.. ونوع الوسائد.. والأغطية ! – ص 12 ).
إنها لعبة حقا تتلاعب بخيوط مصائرنا السوداء الآلهة مستمتعة، في موتنا وفي
حياتنا، وقد أدرك سرّها الشاعر: ( يا للحياة من تابوت مفتوح.. أشعر
أحيانا.. أن الحيّ.. ميت يتنفس.. والميت حي لا يتنفس – ص 11 و12 ). ومن
الشعور العابر إلى القناعة الراسخة بأن الحقيقة الوحيدة في حياتنا هي
موتنا، هذه القناعة التي ألهبت العملية الإبداعية، كطريق دفاعية توفر
الإحساس بالإمتداد والخلود، فجعلت الشاعر يبدع نصه الباهر هذا:
( وحده فأس الموت... يقتلع الأشجار من جذورها... بضربة
واحدة – ص 7 ).
وبقصدية عالية
يخصص الشاعر المقطع الثالث والثلاثين من القصيدة ليقدّم ثلاثة أبيات من
الشعر العمودي تكشف ما قلناه عن الإنفعالية المباشرة التي توفرها إيقاعية
العمود والتفجع الحاد:
( لوأن من شيّعت يُفدى – أبدلت بالدارين لحدا وأن شق الثوب
يجدي – قد شققت عليك جلدا وأذبت شحم المقلتين – تفجعا ولطمت خدّا – ص 29 ).
وحين نراجع البناء الصوري في هذه القصيدة، وقصائد المجموعة
الأخرى، فسنجد أنها صور سرديّة.. صور ممتدة إذا جاز التعبير، تعتمد على
المشهدية الحركية، على العين السينمائية، وليست مثلما اعتدنا عليه في صور
قصيدة النثر التي تأتي كومضات وضربات حادة. وسيكون لنا مع هذه السمة
الأسلوبية وقفة مقبلة.
----------------------
هوامش:
* شاهدة قبر من رخام الكلمات – نصوص نثرية – يحيى السماوي –
دار التكوين – دمشق – 2009.
** أفكار لأزمنة الحرب والموت – سجموند فرويد – ترجمة سمير
كرم – دار الطليعة – ط/3 – 1986.



